تحتضن منطقة الجزيرة عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني المحلي التي تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وبشكل أصغر في مجال التنمية المستدامة والتي تسعى بدورها إلى تحقيق نوع من الاستقرار ضمن المجتمعات التي تنفذ فيها.
تعاني هذه المنظمات المحلية من قلة فرص التمويل وشحّها، إن صح التعبير وهذا يؤثّر بشكلٍ مباشر على فرص استمراريتها وتواجدها كقوى مدنية قادرة على التأثير في المجتمعات بشكلٍ إيجابي وفرض واقعٍ مدني فعّال ومؤثّر ناتج عن التعاون والتنسيق المستمر مع القطاعين الخاص والحكومي.
تختلف أسباب نقص تمويل المجتمع المدني المحلي في منطقة الجزيرة باختلاف المنظمات التي تستفسر منها عن أسباب نقص تمويلها، فمنها ما يكون عائداً لأسبابٍ سياسية متعلّقة بالحرب الأهلية السورية وتأثيراتها المباشرة على التنافس المدني، ومنها ما يكون لأسبابٍ إدارية وتنظيمية، وأخرى تتعلّق بسياسات المؤسسات المانحة التي قد لا تكون من أولوياتها التركيزعلى مناطق منطقة الجزيرة.
ولكن يحسب على هذه المنظمات، أنها لم تستطع إقناع المؤسسات المانحة بتمويلها، ما يضعنا أمام تساؤلاتٍ حول قدراتها على تنفيذ المشاريع أو البرامج الإغاثية أو التنموية بشكلٍ مؤثّر وفعّال في المناطق التي تعمل فيها.
هناك عددٌ لا بأس به من هذه المنظمات تفتقد المعايير الدنيا لمؤسسة مدنية قد تطلبها المؤسسات الدولية المانحة عند تقديم المنح لها، حيث لا وجود لرؤية واضحة أو هدف استراتيجي واضح من إنشاء هذه المنظمة إلا مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين وتقديم المساعدات الإنسانية على حد قول البعض من ممثلي هذه المنظمات.
ما الذي ينبغي لمنظمةٍ مدنية امتلاكه عند الشروع في التقديم على منح الدولية أو الإقليمية؟
إن امتلاك رؤية ومهام وقيم مدنية واضحة، هي الخطوات الأساسية الأولى التي يجب أن تتخذها عندما تقوم بتمويل أو إنشاء منظمة ما، وهي تعد البوصلة الرئيسة التي توجّه عمل المنظمات، والتي تساعد بتوجيه كل نشاط أو قرار أو أية برامج ومشاريع تنوي هذه المنظمة القيام بها.
تصف رؤية المنظمة شكل المنطقة التي تخدم فيها وهي تكون صورة للواقع الذي تسعى لخلقه وكيف ستؤثر على حياة الناس أو المجتمعات نتيجة للمشاريع التي ستقوم بها، بينما تشرح مهام المنظمة بإيجاز الغرض الرئيس من إنشاء المنظمة، ما هي الأنشطة التي تقوم بها، والنتائج النهائية التي تسعى لها.
تتمثّل قيم المنظمة، بأنها المبادئ الرئيسة التي ينبغي على المنظمة التمسّك بجميع جوانبها، ويرى البعض أنها مرتبطة بجودة العمل، بينما يحددها البعض الآخر بطبيعة العمل الذي تقوم به المنظمة.
مع انتهاء تحديد القيم الأساسية للمنظمة، ينبغي على المؤسسين استخدامها في سبيل رسم القرارات حول طبيعة النشاطات والمشاريع أو البرامج التي قد تنفّذ لاحقاً مع الأخذ بالاعتبار (معايير اسفير) الإنسانية المتضمنة للميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في الاستجابة الإنسانية.
كما ينبغي لهذه المنظمات امتلاك سياسات عملياتية ومالية داعمة واضحة تراعي أو تتوافق بشكل جزئي مع سياسات المانحين التي يبحث عنها غالبية المانحين الدوليين كالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أو وكالة التنمية البريطانية (UKAID) أو إدارة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO) وغيرهم من المانحين.

تضم السياسات العملياتية بشكل رئيسي إدارة الموارد البشرية التي تهتم بالسياسات التوظيفية والالتزام بساعات العمل، إضافةً إلى كتابة عقود الموظفين وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المنظمة، كما تضمّ سياسات العمليات الشرائية سواء كانت هذه العمليات لشراء مواد وبضائع عينية بطريقة مباشرة أو عن طريق الموردين أو كانت شراء خدمات من شركاء العمل كالتعاقد مع بعض شركات البناء لإعادة تأهيل الأبنية المتضررة على سبيل المثال.
كما يعتبر قسم التنسيق الحكومي وسلامة وأمن الموظفين الذي يقوم بتدريب وتهيئة الموظفين للعمل ضمن البيئات المعقدة والخطرة أمنياّ، وتقييم الوضع الأمني والمخاطر الأمنية المحتملة للمشاريع المخطط تنفيذها في المناطق المستهدفة جزءاً من العمليات، وتعدّ أقسام اللوجستيات وصيانة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية أيضاً من الأقسام التي تتبع أو تكون جزءاً من العمليات.
تضم السياسات المالية ضبط حركة المال الداخلية والخارجية للمنظمة خصوصاً المرتبطة بالمصارف، إضافة إلى إدارة الأموال والدفعات في العمليات الشرائية الصحيحة وتوثيق وأرشفة كافة الفواتير والدفعات المالية والأوراق المرتبطة بها ضمن ترتيب معين يتوافق مع السياسات الداخلية للمنظمة وفقاً لمتطلبات المانحين الذين قد يطلبون الأرشفة الإلكترونية والورقية على حد سواء، حيث تصل مدة الاحتفاظ بأرشيف البرامج الممولة من قبل بعض المانحين لما يزيد عن سبع سنوات.
كما تشمل جداول الحسابات التي تنظم كافة العمليات المالية بما فيها تحديد رواتب الموظفين والتأمينات الاجتماعية وفقاً لقوانين عمل المناطق المحلية التي تعمل فيها.
أما فيما يتعلق بتنفيذ البرامج أو المشاريع الإغاثية أو التنموية على حد سواء، فينبغي لكل منظمة أن تمتلك على الأقل ثلاثة أقسام تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع بعضها البعض ومع الأقسام الداعمة لها (قسم العمليات والقسم المالي) في سبيل تطوير المشاريع أو البرامج وتنفيذها.
أول هذه الأقسام هو(قسم تنفيذ المشاريع وتطويرها) الذي يضم بالعادة الفرق المكلّفة بتنفيذ المشاريع وكتابة مقترحات مشاريع إغاثية أو تنموية وفقاً للحاجات المجتمعية، والذي يعمل بشكلٍ وثيق لا ينفصل عن القسم الثاني (قسم المتابعة والتقييم والتعلُّم والمساءلة (MEAL) الذي يقوم بشكل وثيق مع القسم الثالث (قسم إدارة البيانات) بجمع البيانات الكمية والنوعية عم طريق الاستبيانات الورقية أو الإلكترونية أو المقابلات الفردية أو الجماعية، ومن ثم تحليل هذه البيانات وتطوير أبحاث تحتوي على بيانات دقيقة تساعد على إعطاء تصورات واضحة للمشاريع التي تحتاجها المنطقة فعلياً ويعكس تنفيذها تأثيراً إيجابياً على المجتمعات الموجودة هناك.
عوامل إضافية تسهم في مأسسة المنظمات وحوكمتها وتزيد من فرص تحصيلها للدعم:
إن تطوير أية منظمة لعلاقات عامة لفتح قنوات اتصال مع المنظمات العاملة في المنطقة والجهات المانحة (أفراد أو مؤسسات) وفق رؤية المنظمة وقيمها واستراتيجيتها بعيداً عن المزاجية وتشخيص هذه العلاقات؛ يعد أمراً حيوياً لاستدامة وجود المنظمة وتطوير عملها عن طريق الدخول في شراكات استراتيجية مع نظرائها من المنظمات الأخرى أو المانحين أنفسهم.
إضافةً إلى ما ذكر، ينبغي أن تكون آلية صناعة القرارات للرؤى والسياسات وتنفيذ البرامج آلية جماعية يعمل عليها كل من المؤسسين والموظفين على حد سواء مع إعطاء مرونة وحد أقصى للتأثير على غالبية الموظفين وفقاً لهيكليةٍ هرمية يتم التوافق عليها مسبقاً، مع التذكير بأن القرارات الفردية تعيق حوكمة المنظمة ومأسستها وتزيد من فرص الاستغلال والفساد الإداري والمالي الذي يهدد مستقبل المنظمة وفرصها في العمل وتحصيل الدعم.
كما هو معلوم، أن بيئة العمل الإنساني هي بيئة تعليمية باستمرار، وفي حالة تطوّر مستمر، وسيكون من الضروري للعاملين في هذا المجال؛ اكتساب المعرفة والخبرة باستمرار، وذلك عن طريق المشاريع المُنفّذة أولاً، وثانياً عبر تقديم دورات تطويرية مستمرة وإتاحة الوصول إلى منصّات التعلم الإلكتروني الأكاديمية مثل Coursera أو المنصات التقنية التطويرية المرتبطة بالعمل الإنساني مثل Disaster Ready أو Relief Web.
حقيقة القول، لا يخفَ على العاملين في الشأن المدني العام حقيقة دخول عوامل أخرى في عمليات الدعم والتمويل المدني، غير أن تمكين طواقم المنظمات المحلية وبناء قدراتهم وتطوير سياسات وإجراءات المنظمات المحلية هي أول خطوة في خرق الجدار الصلب القائم بين هذه المنظمات وبين تحصيلها للدعم، وبالتالي استمرارية وجودها واستدامة تأثير نشاطاتها على المجتمعات المستهدفة.
التحضير لتوطين المساعدات الإنسانية:
طورت قمة اسطنبول العالمية للعمل الإنساني سنة 2016 (World Humanitarian Summit 2016) نقاشات عديدة تمخض عنها (ميثاق من أجل التغيير) الذي أرسلت نسخة مُنقّحة منه إلى المنظمات المحلية والدولية للتوقيع عليها في آذار ونيسان 2019.
ينصّ هذا الميثاق على توطين المساعدات الإنسانية وزيادة تفعيل دور المنظمات المحلية في الاستجابة الإنسانية عن طريق ثمانِ نقاطٍ سيتم العمل بها مع مطلع 2020، حيث ستلتزم المنظمات الدولية الموقّعة على هذه الاتفاقية، على تحويل 25% من تمويلها المباشر للمنظمات المحلية وتقديم هذه المنظمات للمانحين مباشرة، في محاولةٍ منها للضغط والتأثير على سياسات الجهات المانحة في أميركا الشمالية وأوروبا لتشجيعهم على زيادة نسبة الدعم بشكلٍ متزايد سنوياً من تمويلهم الإنساني إلى المنظمات غير الحكومية المحلية.
كما ستعمل المنظمات الدولية الموقّعة على الميثاق على أن يدخل الشركاء المحليون في تصميم البرامج والمشاريع منذ البداية والمساهمة في صنع القرار على قدم المساواة في التأثير على تصميم البرامج وسياسات الشراكة، إضافةً إلى التزامها بسياسات توظيف عادلة للحد من استقطاب موظفي المنظمات المحلية، لأن ذلك يساهم بشدة في تقويض وإضعاف القدرات المحلية.
وستلتزم المنظمات الموقّعة على الميثاق أيضاً، بتغطية التكاليف الإدارية بشكلٍ كافي، وتعمل على تخصيص نسب مئوية محدّدة تذهب مباشرةً إلى تطوير وبناء قدرات الشركاء المحليين.
وأخيراً، ستقوم المنظمات الدولية بالتأكيد على دور الجهات المحلية الفاعلة أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية وستضيفهم كمتحدثين إن سمحت الاعتبارات الأمنية بذلك.
في ظل التوسّع غير المسبوق في القطاع الإنساني الناتج عن وصول الحاجات الإنسانية فيه إلى مستويات عالية من الحاجة للمساعدات والمشاريع الإنسانية، وفي طور التوجه نحو توطين المساعدات الإنسانية، يتحتم على العاملين في منظمات المجتمع المدني في منطقة الجزيرة وفي سوريا ككل، البدء بعمليات المأسسة والحوكمة كي تسير وتعمل وفقاً للحقائق على الأرض، للمساهمة في تغطية حاجات المكونات المجتمعية ومن ثم العمل على تعزيز حالة الاستقرار والتجانس المجتمعي بين مختلف مكونات منطقة الجزيرة.


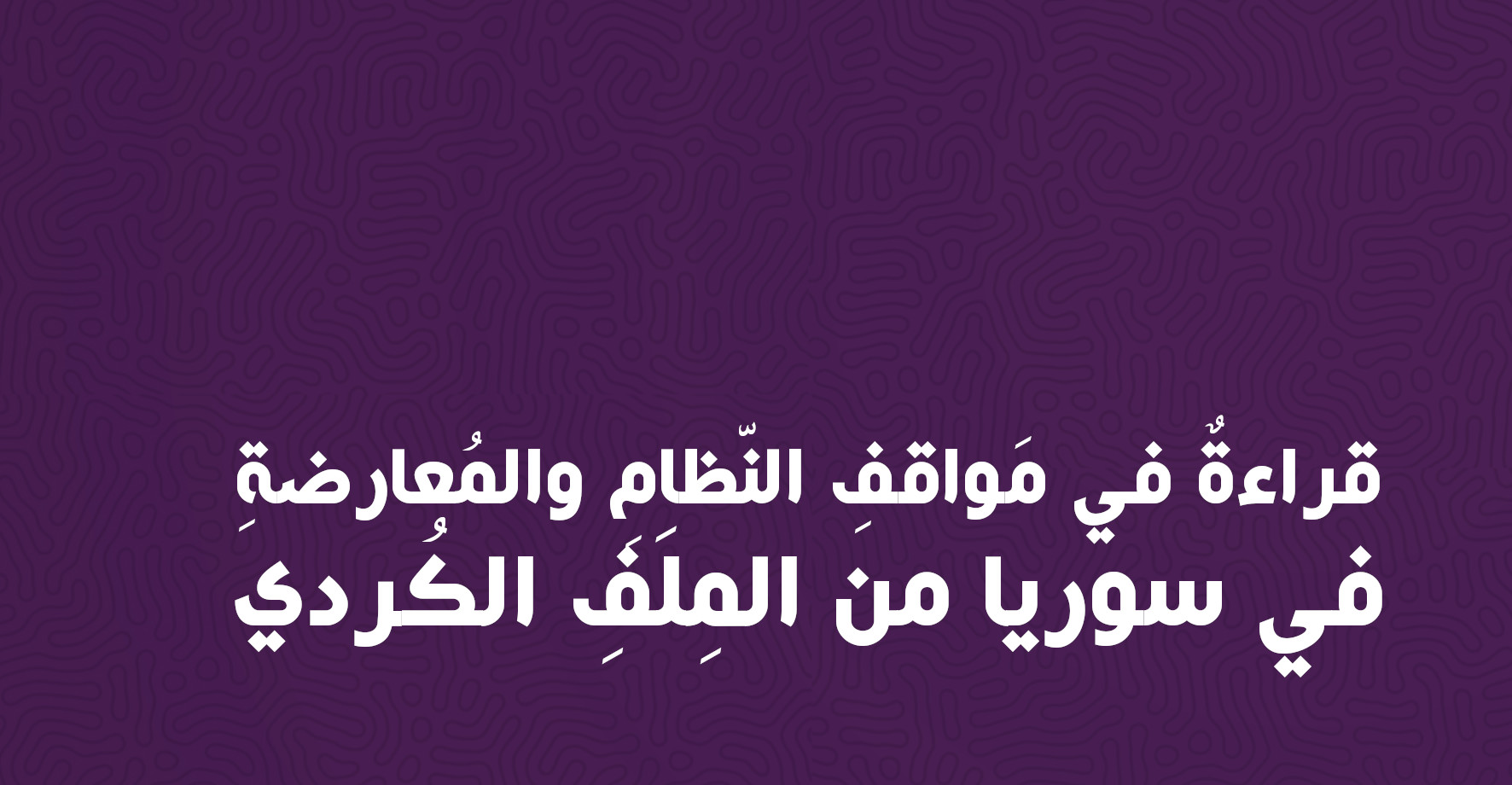
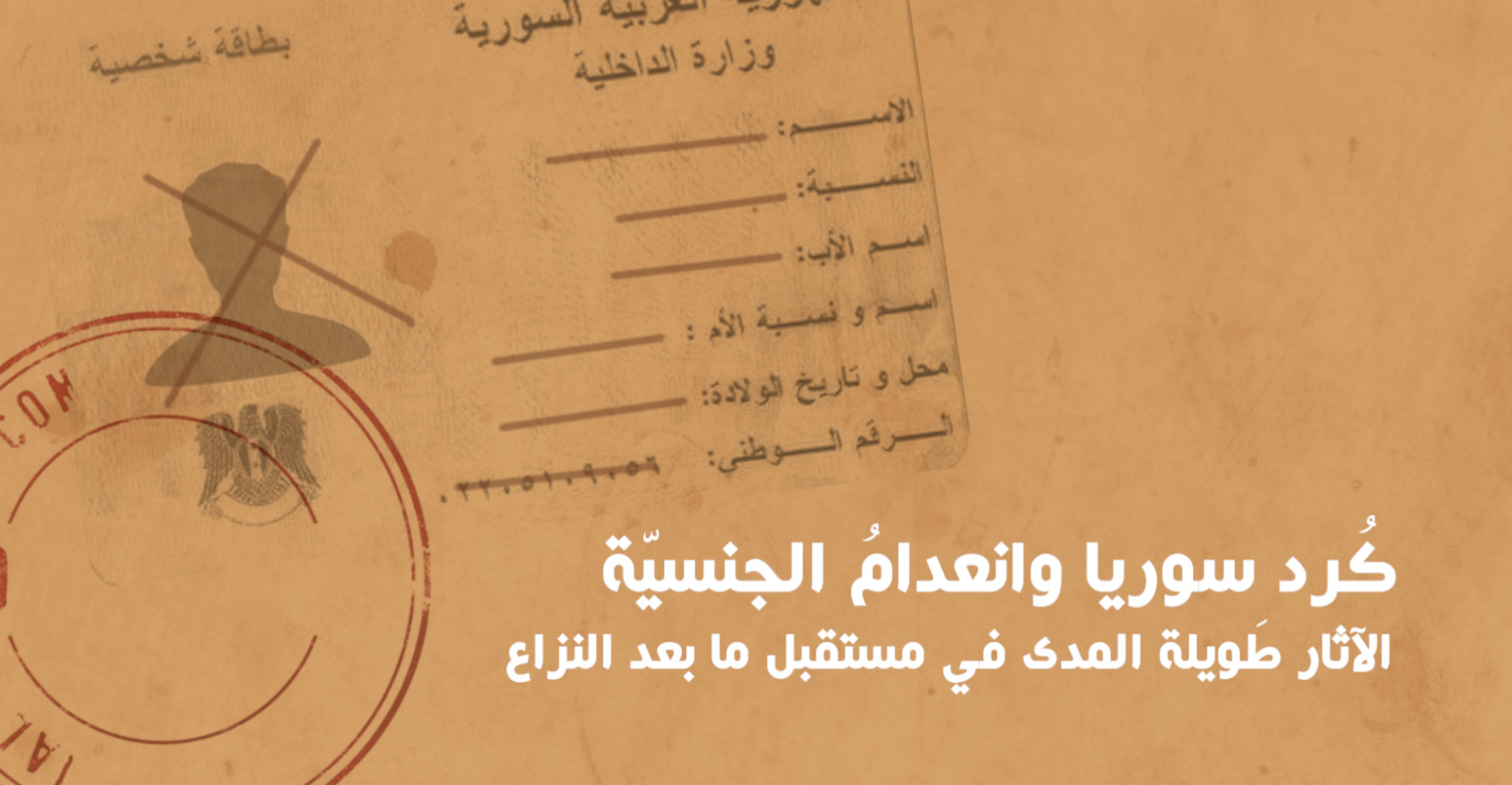
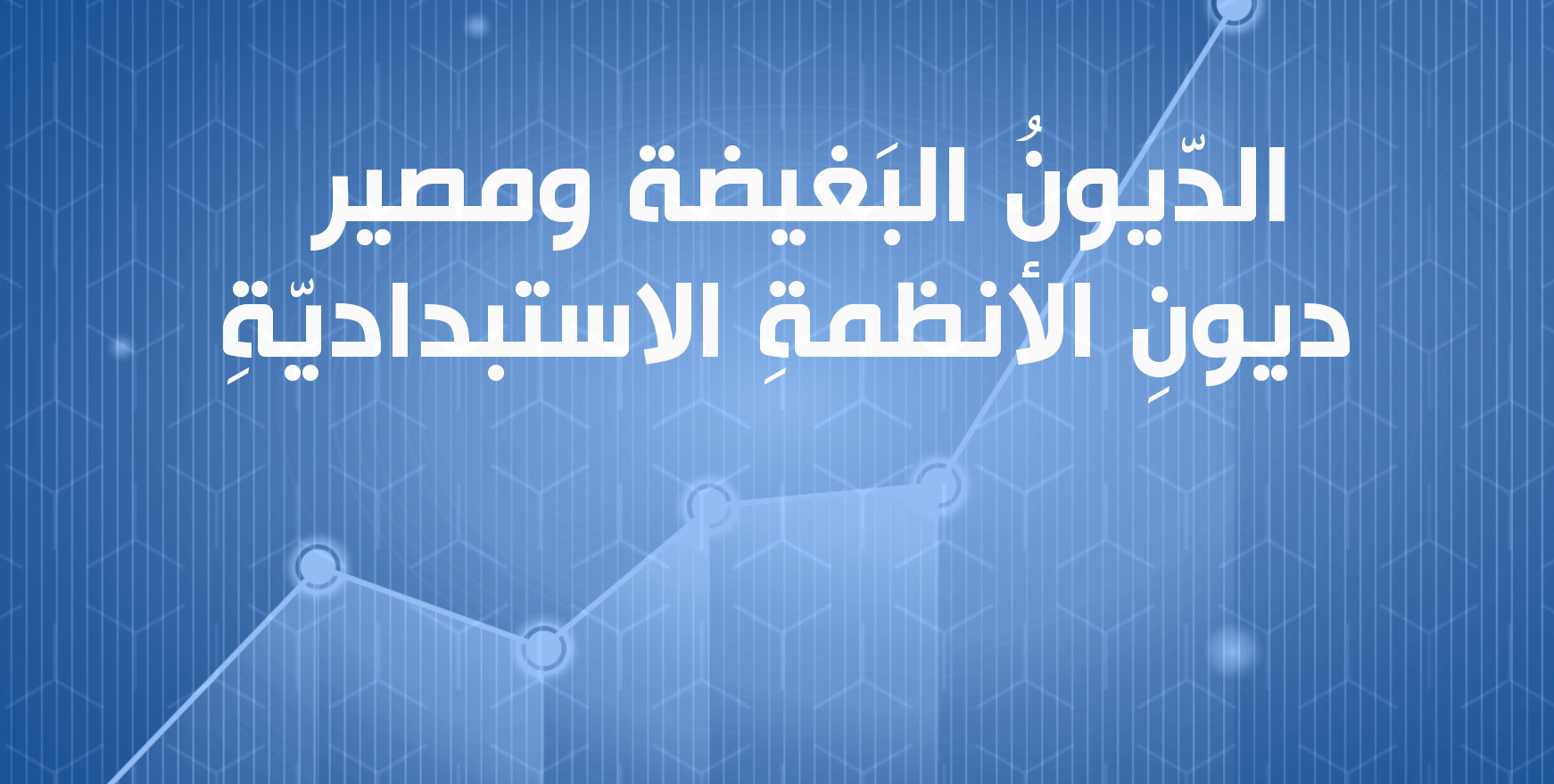

38 replies on “عن الحاجة لتطوير منظمات المجتمع المدني في منطقة الجزيرة”
3database
ghost writer for college papers https://term-paper-help.org/
writing paper services https://sociologypapershelp.com/
buy a literature review paper https://uktermpaperwriters.com/
buy psychology papers https://paperwritinghq.com/
paper writing help https://writepapersformoney.com/
https://write-my-paper-for-me.org/
help with writing paper https://doyourpapersonline.com/
buy resume paper https://top100custompapernapkins.com/
buy paper online https://researchpaperswriting.org/
write my business paper https://cheapcustompaper.org/
pay someone to write a paper for me https://writingpaperservice.net/
college paper writing service https://buyessaypaperz.com/
do my paper https://mypaperwritinghelp.com/
finished custom writing paper https://writemypaperquick.com/
find someone to write my college paper https://essaybuypaper.com/
help with papers https://premiumpapershelp.com/
write my papers https://studentpaperhelp.com/
2infantile
custom coursework writing https://brainycoursework.com/
coursework resources https://courseworkninja.com/
coursework writer https://writingacoursework.com/
coursework writing uk https://mycourseworkhelp.net/
coursework science https://courseworkdownloads.com/
buy coursework https://courseworkinfotest.com/
coursework writer uk https://teachingcoursework.com/
coursework papers https://buycoursework.org/
coursework history https://courseworkdomau.com/
best dating site online https://freewebdating.net/
local dating site https://jewish-dating-online.net/
date free site https://free-dating-sites-free-personals.com/
dating sim https://sexanddatingonline.com/
datiing websites https://onlinedatingsurvey.com/
international dating sites https://onlinedatingsuccessguide.com/
lightdatings life https://onlinedatinghunks.com/
100% free dating service https://datingwebsiteshopper.com/
casual dating sites https://allaboutdatingsites.com/
plentyoffish https://freedatinglive.com/
Comments are closed.